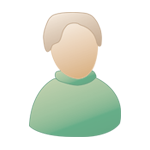بسم الله الرحمن الرحيم
ملحوظة : هذه دراسة فنية لا تمثل موقفا فكريا
بقلم : عماد الزبــن
أـــ توطئة
يعد ابن الفارض بحق من أبرز شعراء العصر الأيوبي ، ورائد من كتب في الشعر الصوفي بعده، وكان صاحب مذهب في التلويح الصوفي والإشارية المغرقة ، يشهد بهذا شعره الذي يدخلك في سيميائيات غنوصية يصعب عليك معها إلا أن تتجرد عن حسك لتجاري تلويحات سلطان العاشقين ، وابن الفارض في شعره يضايف بين التجربة الصوفية والفنية الشعرية ؛ الأمر الذي أغنى شعره بالرموز والإشارات والتلويحات ؛ ولا أظنني أبالغ إذا قلت إنه جدد في طريقة التلويح والتعبير الإشاري في عرض المواجيد والحالات والانجذابات التي عبر عنها عبر جريان الرمز الصوفي؛ المشعر بضيق اللغة الحسية عن دوائر اللامعقول ، والتجليات الميتافيزيقية للروح ،" لقد كان صوفيا غلبه السكر، واستبدت به النشوة ، يسمع فيستخفه الوجد ، وتغشى أعضاءه الحركة، ويقهره وارد السمع، فلا يملك له صرفا" فيسوح في سبل الفناء؛ يطوي واردات البقاء، ليظل في شهود المشهود، هوعالم من التلاقي يكسر حاجز المعقول والحس، ولا يصلح البوح به إلا بكسر حسيات اللغة، حتى تنتظم اللغة بما يشبه الازدواجية الدلالية بين البقاء المحس ، خطاب العامة، والتجلي المبني على الفناء، خطاب الخاصة الخالصة، وهو بهذا يعبر عن تجربة وجدانية لها مقتضياتها التي تشحن اللغة بحالة من التوتر الدلالي، يظهر بهذه التلويحات والإشاريات الميثوصوفية ، وهو يخط طريقا، ويبني ما يمكن أن أسميه منهجا في الشعر الصوفي، ظهر من خلال السمات الرمزية والانزياح الرمزي ، كما وكيفا ، عما كان قبله، وتظهر قيمة هذه السبيل، بالشعراء السالكين من بعده، الذين مخروا عباب بحره اللجي ، ونسجوا على منواله الخفي ، في إشاراياتهم ورموزهم ، وتجلياتهم الماورائية .
ولما كان الرمز من أعظم سمات الشعر الصوفي، وأجلاها في الفضاء الروحي الذي ينداح فيه شعراء التصوف بتجاربهم الوجدانية، رأيت أن أقصر تقريري هذا عليه ؛ منطلقا من قراءة خمرية ابن الفارض التي ربما يسوغ لي أن أسميها المثال الأسمى للتجربة الشعرية الصوفية .
ب ــ الرمز الخمري : الحس والتأويل
يقرر عبد الغني النابلسي ، شارح ديوان ابن الفارض، أن هذه القصيدة مبنية على اصطلاح الصوفية،1فيدفع القارئ في بداية نظره في هذه القصيدة، إلى رفع حجب الحس عن دلالاتها ومضامينها، وأنت خبير بعد، بأن هذه القصيدة مؤسسة على رمز الخمر والسكر في الأدبيات الصوفية؛لذلك عمد بعض الشراح إلى وسمها بالخمرية .
( 1 )
لجأ ابن الفارض وهو يعبر عن الحب الإلهي إلى الخمر والمدامة، ووشاها بالرمزية الدالة على الأزلية، أراد بهذا الرمز أن يكسر ضيق الزمان والمكان؛ ليعبر عن تجربة لا تحدها قيود الزمان و المكان، أراد أن يعبر بالخمر والسكر عن غيبة تكسر طوق الالتزام بعالم الأشباح، والغيبة هنا فناء عن ملاحظة التكثر، والسكر انتشاء بما أداره الحبيب على ألباب السكارى من لذة التوحد والقرب والمعرفة2، والخمر بهذا التلويح توجب الغيبة عن جميع الأعيان الكونية،غيبة تكسر طوق : قبل وبعد ومتى، ليتلذذ السكارى بنشوة التلاقي الروحي في سابق الحضرة العلمية قبل ظهور كل ممكن ، وتقدير كل مقدور،فيغدو السكر استجابة لوارد قوي لا يتجلى إلا في نفس قابلة متمردة على سجن الأشباح، إنها نفوس أصحاب المواجيد وجزء من مقام الولاية فالخمر هنا ليست الخمر الحسية، بل رمز يحملنا على التأويل الصادر عن كسر حجاب الحسيات، وهذا التأويل مرتبط بالأثر النفسي والروحي؛ فالسكر الصوفي غيبة وليس غشية، خمر معنوية ترجع الروح إلى الاتحاد مع المحبوب، الذي يمثل حبه أصل وجود المتعينات، والمعنى الحقيقي لحركة المتحركات.
ولم يدر ابن الفارض خمريته على لغة تجريدية جافة، وإنما ساقها مشربة بالرمز جياشة بالصور،فجاءت لغة موسومة بطابع الوحدة الصوفية ، وجاءت الخمر فيها تعبيرا جياشا عن افتراق الروح وهجرة النفس بوارد الجمال الإلهي ، خمر أزلية شربتها الأرواح المجردة؛ فانتشت وطربت وترقى مزاجها ، من قبل أن تحصر في عالم المحدثات المسور بسجن الإمكان
شربنا على ذكر الحبــيب مدامــــة سكرنا بها من قبل أن يــُخلق الكرم
لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال ، وكم يبــدو إذا مزجــت نــجم
ولولا شـــذاها ما اهتـــديت لحانها ولولا ســــــناها ما تصورها الوهم
ولم يُبق منها الدهر غير حُــشاشة كأن خَفاها في صــــدور النهى كتم
وإذا كانت المدامة رمز الحب الإلهي الأزلي، فإن شاعرنا يغرقنا في نهر جار عذب من الرموز المرتبطة بالخمر، الأمر الذي يحملنا على تأويل هذه التلويحات في فضاء المعنى المومى إليه في عين المحبة الأزلية، فهذه رموز تمظهر المحبة الأزلية، إنها مظاهر الآثار الكونية التي تعكس هذه المحبة بما يشبه الانعكاس المرآوي ، فالشمس هي محبة الإله وإشراق لطفه، ووارد جماله على البواطن القابلة المستجيبة المشرقة بهذه الاستجابة ، إنسان كامل مرموز إليه بالبدر الذي يستضيء بشعاع وارد المحبة، وبالكأس من حيث هو مظهر للمقام الأعلى، وبالهلال إذا احتجب بظهور نفسه عن إظهار بقية النور، وبالنجم إذا نظر إلى غيره، وانقطع وارد اتحاده بملاحظة الأغيار، فمزجت محبة الإله بمحبة الغير .
وهذه المدامة المكنى بها عن الحقيقة الجامعة الوجودية الإلهية ، تظهر كالبرق وتلمع في النفس كلمح البصر، فلولا روائح تلك الحضرات الحاملة للسر المصون ما استعلنت هذه المحبة، فأنت ترى أن الشاعر يستعين بكل ما يجاور الخمر من ألفاظ : الكأس والشذا والحانة والروائح و الحشاشة ، ويعبر بها عن تجربة روحية لا تستعلن إلا وهي تلجئنا إلى محاضن التأويل، بل إن شاعرنا يقرر أن الركون إلى المحسّ، والاقتصار على التعقل المجرد يقصي فهم هذه التجربة الروحية، ويدخلها في الزخارف العقلية المحسة ، فلا يبقى من هذه المدامة في القلوب حشاشة روحية، أو بقية روح أمرية .
ولم يُبق منها الدهر غير حُــشاشة كأن خَفاها في صــــدور النهى كتم
(2)
وما زال شاعرنا يمتح من فيض اللذة الروحية، ما يشعرنا بضيق اللغة الخاضــعة للمواضعة المحسة، فأنى لمن تريض في مضمار عين المحبة الإلهية، أن يرتكس بملاحظة الدلالات الوضعية، وهذا ما يشعر القارئ بالتوتر الدلالي وهو يسوح في فضاء الخمرية الفارضية. ويهبط المستوى الخطابي الروحي عند شاعرنا ، أحيانا، ليذكرنا أن خمر الروح ومدامة الوجد لا يبتنى عليها إنكار أو إثم، بل هي إشراق أنوار التجليات الإلهية على قلوب الذاكرين، الناسخة لظلمات الغفلة والركون إلى الأغيار، وكأنه بهذا فقد وارد الاتحاد بملاحظة أحكام الأغيار على التجربة الروحية، والذي يؤكد ما قلته أنه ينعى على المريدين الصادقين خفاء العلوم الإلهية من صدورهم، لتقاصر هممهم، فلم يبق منها إلا الاسم، وكأنني بابن الفارض ينعى نفسه التي فقدت هذا الوارد من التجلي؛ بما تحقق لها من الأنس بغير مدامته الأزلية، فهي كما تقرر سابقا، كلمح البصر، ظهورا وخفاء، تظهر في نفسه وتغيب، فلا غرو بعد، أن يبين شاعرنا أثرها في النفس القابلة وما تشيعه في النفس من أفراح ونفي للهموم .
فإن ذُكرت في الحي أصبح أهله نشاوى ولا عار عليـــــــهم ولا إثم
ومن بين أحشاء الدنان تصاعدت ولم يبق منها، في الحقيقة، إلا اسم
وإن خطرت يوما على خاطر امرئ أقامـــت به الأفراحُ وارتحل الهــــم
وتظهر هنا الدنان وبعدها الرمزي المرتبط بالخمر، فهي صدور المريدين التي غابت عنها الحقيقة المدامية، وهؤلاء المريدون هم أهل الحي، أصحاب النفوس القابلة لهذا التجلي للحقيقة المدامية .
(3)
وقد بدا بوضوح، أن ما ذكره ابن الفارض في خمريته، ينحل إلى ضرب من التكافؤ بين البنية الحسية للأشياء في قربها ومباشرتها، والبنية العرفانية المرموزة، وفي هذا الفضاء من الازدواج يؤول ما نسبه الشاعر إلى الخمر من صفات وآثار في النفوس إلى كيفيات يسيطر عليها طابع التلويح الرمزي، وتكتنفها التجليات السيميائية التى، دون اعتبارها، تجد نفسك تقرأ في فضاء خارج عن مراد شاعرنا، وتطير خارج السرب الوجداني الذي يتعنى تقريره، وهذا في قصيدته كالميت بالجهالات والشهوات، يبعث إذا ما ذاق هذه المدامة الإلهية، والمقعد الذي لا نهوض له إلى معرفة ربه، فإنه متى ولج ليل الوجد، وسكر بشراب المحبة المنزهة؛ أنهضه هذا الشراب وابتعث إرادته وهمته، وكذلك المزكوم الذي لا يشتم طيب الأنفاس الرحمانية، ولا يجد عــَرف التجلي الإلهي في الأكوان، وهي بعد ذلك نجم يهدي ورقيقة تشفي، وذوق يهذب أخلاق السالكين، وسكر يفضي إلى العزم،1إنها نشوة روحية تحيل النفس إلى غير طباعها، وتخرق مألوف التردي في هذه النفوس؛ لأنها هجرة روحية تتعالى على مقتضيات البقاء الحسي، لتدّغم في أحكام الكمال الروحي الأزلي .
ولو نظر النُدمان ختم إنائـــــها لأســـكرهم من دونها ذلك الــختم
ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعـش الجسم
ولو طرحوا في فيء حائط كرمها عليلا وقد أشفى لفارقه الســــــــقم
ولو قربوا من حانها مقعدا مــــشى وينطق من ذكــرى مذاقتها البـــكم
ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها وفي الغرب مزكوم لعاد له الـــشم
ولو خُضّــبت من كأسها كف لامس لما ضل في ليل وفي يده النــــــجم
ولو جليت ســـــرا على أكمــهٍ غدا بصيرا، ومن راووقها تـَسمع الصمّ
ولو نال فَــــَدم القــوم لثــم فِــدامها لأكــسـبه معنى شـــــــــمائلها اللثم
ولو رسم الراقي حروف اسمها على جبين مصاب جنّ ، أبرأه الرســــم
تهـــذب أخـــلاق النــَدامى فيهــــتدي بها لطـــريق العزم من لا له عزم
ويـــــَكرُم من لم يعرف الجـــودَ كفّـــُه ويحلُم عند الغيـــظ من لا له حِــلم
ولو أن ركبا يــمموا تــرب أرضـــــها وفي الركب ملسوع لما ضره السم
(4 )
وخمر ابن الفارض ، خمر معتقة في أعطاف الأزل 3، يعنى شاعرنا بتقرير تعاليها عن الوصف، وعند وصفها يطرح رموزا أجاءتنا إلى تأويل هذا التلويح الجديد من واقع التذوق الذي يستعصي على غير أصحاب الذوق، فما لنا من حظ في تفهم هذا المشرب الراقي الذي يعبر عنه صاحبنا، إلا بمقدار ما نلاحظ المناسبة الحسية في طرحه الروحي، شيء يشبه التناص بين الروحاني والترابي؛ للوصول إلى رتبة مشوبة بهذه المعاني المستغلقة من تجليات الروح، نسل بها إلى التجربة المدامية لفارضية.
ويتقرر في فضاء الرمز في خمرية ابن الفارض الفرق بين ذات المحبوب ، والمحبة المعبر عنها بالمدامة، فابن الفارض عندما يُسأل عن أوصاف المدامة ، أي عن طريق المحبة إلى المحبوب، يحتجب إحساسه بغير ادّغامه بها، وتستعلن نفسه الخبيرة بهذه الأذواق، فعنده وصفها وهو الخبير بها، ولا يحملنك هذا على الشعور بتناقض مواقفه إذا قرأت قوله في التائية
فلو قيل من تهوى وصرحت باسمها لقيل : كنَـى ، أو مسه طيف جنة
فهو في التائية يشير إلى نفس الحبيب، وعلمه ليس سهلا ، ومن شأن العارفين نفي قرب معرفة نفس الحبيب، ومنه قول العارف السيد أحمد الرفاعي:
يسائلني عن سر ليلى رددته بعمياء من ليلى بغير يقين
يقولون خبرنا فأنت أمينها وما أنا إن خبرتهم بأميــن
ويبدأ ابن الفارض في بيان أوصاف المدامة، فلم يبق من الخمر في شعره إلا اسمها، إذ إنه نزع عنها الثوب الحسي الذي ترفل فيه في فضاء الصورة الذهنية، وحرمها التحقق، وجعلها تنأى بجوهرها عن دلالة الوضع، فليس ثَـم إلا السكر والغيبة والانتشاء ، ويمكن أن نقف هنا على الكيفيات التي تحوّل الموضوع بها إلى رمز شعري، فيه إحالة موحدة بين الحسي والمثالي، بين العيني في واقعيته والمجرد في تعاليه، فهذه الخمر تتجاوز المعطى المادي إلى وصيد مثالي مجرد، ويبدو هذا التجريد المثالي في وصف الخمر العرفانية بالخلوص من كثافة العناصر، فهي صافية نورانية 3، تتجلى بالمعاني المجردة، لا الصور المحسة، لا يتعنى شاربها كدورة الخمر الحسية، وهي روح مجرد عن دواعي الجسمية، وعن رسوم الأعيان، سابقة لكل متعين، متعينة في حضرة العلم الإلهي الأزلي، ثم يجعل من هذه الخمر النورانية محل قيام المتعين، ويتوسل بالرمز إلى معنى احتجابها عن المحجوبين الدائرين في فلك المحسات، بتعاطي ما يجتال قلوبهم بعوائق التشوق إلى زخارف الدنيا، ثم يقيم شاعرنا بمنظومة رمزية، ثنائية اعتبار الوجود من خلال الملاحظة، فالروح المتعينة في العلم الإلهي امتزجت واتحدت بهذه المدامة، وهامت بها قبل كينونة العوالم التي لا وجود لها إلا بالوجود الظاهر عليها وهو وجود الحق، فهي " ثنائية عرفانية بين التجلي الأمري الوجودي وعالم الإمكان، وتشير إلى أن الصوفي العارف يتلون بها، فتارة لا يشهد إلا الخمر بوصفها رمزا على العلو، ... وتارة لا يشهد إلا الكرم فيكون في مقام الفرق، ولا خمر في هذه الحال موجودة؛ لأن الوجود واحد"
يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير ، أجل عندي بأوصافها علم
صـــفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جســــم
تقدم كلَّ الكائنـــــــــات وجودُها قديما ولا شكل هناك ولا رســـــم
وقامت بها الأشــياء ثَــم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم
وهامت بها روحي بحيث تمازجا اتـــ ــحادا ولا جـــــرم تخلله جــــــرم
فخـــمر ولا كــرم ، وآدم لي أب وكرم ولا خمـــــر ولي أمـُــــها أم
ولطف الأواني في الحقيقية تابع للطــف المعاني والمعاني بها تنمو
وقد وقع التفــــريق والكل واحد فأرواحنا خمر وأشــــــــباحنا كرم
وانظر كيف يرمز بالأواني إلى عالم الإمكان، وأنها في حقيقية الأمر الإلهي تابعة للطف المعاني
التي هي دوالّ صور الممكنات على الحضرات الإلهية، والتجليات الربانية، وهو ما لا يدرك بالعقول، وينأى عن منافذ الحواس.
( 5)
ثم يختم شاعرنا قصيدته بأبيات استقرت في صميم الرمز العرفاني، وكأنه تخلى عن تجرده ليواكب لغة الخمريين في طابعها الحسي، مهيبا في رمزيته الصوفية بلغة لا يكشف ظاهرها بقدر ما يغطي ويعمي، حتى إنه ليتوسل بألفاظ تثير انطباعات مستمدة من لغة شعراء العبث والمجون1، ويقيم ما يشبه المحاججة في نفي الإثم عن شرب مدامته، ويقرر أن ترك شربها هو الإثم، وهو بهذا يلوح إلى نفي الحسية عن مدامته، ولا يفتأ شاعرنا يذكرنا بتجرد مدامته عما نعبه من أغوار أذهننا من صور محسة، وتتكثف رموزه وتلويحاته في سيميائية مغرقة؛ لتغوير منابع المألوف ، وتكدير مشارع المعقول، إن رموزه كسر لحجب الإلف، وخرق لعادية المنظومة اللغوية الدلالية، وقهر لسطوة التعالي العقلي، وتحكمات الحواس .
ويتابع شاعرنا المتح من معجم الغزليين الماجنين ، بما يقدمه من حديث عن الحواني والأنغام وترشف رضاب الحبيب، وأنه لا عيش بلا خمر2 ، وما يتبع الخمر من نشوة ونشاط ، ومزج المدامة، ويقدم منظومة إشارية تعتاص على العقول متى شدت إلى إلفها الدلالي، ويجعل مدامته صافية لا تقبل الأخلاط، ملوّحا إلى معنى الجمع الصوفي وهو التوحد في شهود الحق،
وجعل المزج لخمرته بمعنى النزول من حضرة الجمع إلى تكثر الأشباح، الناقض لمعنى التوحد، ودعا إلى تحقق شارب المدامة النورانية ، على فنائه واضمحلاله، في الوجود الحق، الذي هو به موجود، وهذه الرموز لا يحملها على ظاهرها إلا الذي لم يشامّ رائحة الذوق، وهي تتكاثف وتتصاعد لتحقق المضمون الوجودي، وتنفي الوجود المتكثر من حيث هو وجود، بما يؤسس لوحدة الوجود ، ووحدة الشهود، وإذا كانت المدامة ، على ما يقرره النابلسي،3 هي الوجود الحق الواحد الأحد، فإن حانة الخمار تمثل كل شيء، لأن هذا الوجود الحق له ظهور وتجل وانكشاف بتقدير كل شيء وتصويره.
ومن علامات التحول العرفاني لرمز الخمر، الكلام على الأديرة المسيحية والرهبان والنواقيس، بما يذكرنا بالخمريات الحسية في العصر الجاهلي، ويحدثنا الأستاذ عاطف نصرعن وجه الارتباط بين الطقوس المسيحية والخمريات الجاهلية فيقول : ويرجع الارتباط إلى أن نفرا من تجار الخمر كانوا من نصارى الروم، وأن نفرا من الجاليات المسيحية التي اختلطت بالعرب، كانوا يعاقرونها،5 أما الصوفية فقد اتجهت بهذا الارتباط متجها آخر، رمزت من خلاله بأهل الأديرة إلى العرفاء الذين ورثوا مقاما عيسويا روحانيا،6 فهؤلاء الصوفية تذكروا هذه المدامة وأشرفوا بها على عالم الأرواح المجردة عن الظلمات؛ فزج بهم في النور المحمدي الجامع لجميع مقامات الأنبياء. ثم يسعى صاحبنا إلى ذم الصحو الأول الحاصل من انتفاء المدامة النورانية، وصولا إلى الترقي بمعاني الصحو الثاني الحاصل من السكر النوراني؛ لانكشاف الحقائق الأزلية .
وقالوا شـــربت الإثم كلا وإنما شربت التي في تركها عنديَ الإثم
هنيئا لأهل الدير كم سكروا بها وما شربوا منها ولكنهم همّـــوا
فعنديَ منها نشوة قبل نشــــأتي معي أبدا تبقى وإن بلي العظــــــم
عليكَ بها صِرفا وإن شئت مزجها فعدلُـكَ عن ظلم الحبيب هو الظلم
ودونكها في الحان واستـــــجلها به على نغــــم الألحان فهيَ بها غُـنـم
فما ســــــــكنت والهــمَ يوما بموضع كذلك لم يســــــكن مع النغم الغم
وفي سكرة منها ولو عمر ســـــــاعة ترى الدهر عبدا طائعا ولك الحكم
فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحيا ومن لم يمت سكرا بها فاته الحزم
على نفســـــــه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا ســــهم
جـــ ــ نظرة تحليلية في الرمز
يضيق الصوفية باللغة الحسية التي لا تفتأ تنداح في دوائر الأنا المحس، والأين المحيّـز، والكيف على وفق هيئة متعينة، و (المتى ) وقيود الزمن الاعتباري، وإن كانوا يوهمون الوقوف عند المحس، فلستر محبتهم، وسدل الأستار على مكاشفات الأخيار، حالة من ستر الأسرار عمن ارتكس في المحسات من الأغيار، ولعلك تلحظ هذا في ردة فعل ابن عربي الذي ثار عندما حمل بعض الناس تغزله في نظام ، ابنة شيخه، على ظاهره؛ فبادر إلى شرح ديوانه شرحا ذوقيا مؤسسا على التلويح وهتك حجب المحسات، ويعبر القشيري عن إرادة الصوفية بهذا الاتجاه الرمزي بقوله : " قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم، والإجمال والستر على من باينهم في طريقتهم؛ لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب؛ غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها".
وههنا ينجم تسآل: هل كان الصوفية يكتبون لأنفسهم، ولم يكن من إرادة الصوفي المجذوب بالحال أن تستعلن تجربته الروحية بخصائصها الذوقية؟ وإذا كان ذلك كذلك، فلماذا لم تظل هذه التجارب الروحية مدفونة في الصدور؛ فمن أخص قواعدهم أن صدور الأحرار قبور الأسرار4، والذي يبدو لي، أن القوم اعتمدوا الاستقطاب النخبوي في خطابهم؛ وكانت كتاباتهم فيضا عاطفيا تعالى على سدود الأسرار، فراحوا ينأون بخطابهم عن المتبادر إلى أذهان من هم خارج التجربة الروحية، وأحوجهم الاستقطاب النخبوي إلى الانزياح الدلالي ، من الاستعارات والكنايات وأنواع المجاز، بل أحوجهم إلى اعتماد التواضع الذاتي بل ما يشبه الاصطلاح مع النفس ، لذلك وقع هؤلاء المجاذيب بما يشبه الدائرة المغلقة مع أهل الظاهر المحكومين بالمحسات اللغوية الظاهرة، فأنكر هؤلاء أشد الإنكار على المتصوفة ما يجدونه في كتبهم من تلويحات خارج فضاء المحس؛ لأن هؤلاء المنكرين أقاموا منآد ما يقرؤون بثقاف الكليات اللغوية الظاهرة، ولم يشعروا أن القوم يسوحون في فضاء آخر، تندلث فيه الكلمات عارية عن أسمال الدلالة المتواضعة، ومن جهة أخرى انشغل هؤلاء المتصوفة بفضائهم الروحي الرحب عن ملاحظة الأغيار؛ فكان في رد اتهام أهل الظاهر قطع للادّغام الروحي والوحدة الشهودية، وهبوط إلى شواحط أودية الفانيات، فلا يردّ المجذوب قالة الأغيار إلا في حال انقطاع الوارد. وأنت تجد هذا المعنى في موقف رجل مثل الذهبي؛ الذي أبعد النجعة وهو يتكلم على صوفي مثل ابن الفارض، فاتهمه بالكفر والإلحاد؛ وما هذا إلا لأن الذهبي قد غور ينبوع الذوق الروحي في نفسه بما يتعناه من الجرح والتعديل وحسب، وأنت خبير بعد، بأن تفاوت التجربة الصوفية حمل بعض الصوفية على إنكار هذه الرموز وهذه الطريقة من التعاطي مع التجربة الروحية .
عماد أحمد الزبن
28-11-2007, 14:34
(1)
والذي ألجأ الصوفية إلى هذه المنظومات الرمزية، ارتباط فحوى التجربة الصوفية بالمحل المباين للمحسوس، وأعني به القلب، فإذا كان القلب، على حد تعبير الغزالي، خارجا عن إدراك الحواس1؛ فإن عجائب القلب وما يتجلى فيه من فيوض ، وانكشاف عرفاني، لا تخضع للحس أيضا، فالصوفي بهذا يعبر عن غير المحسوس بمثال محسوس، وهذه الازدواجية أدت إلى تعدد وجوه التأويل للرمز الصوفي، لأن التأويل ارتبط بحال القارئ أيضا في جهة من الجهات، أقصد حاله الروحي، فصار التأويل يستعلن في النفوس القابلة لهذا المشرب الروحي بصورة مجردة أكثر مما يستعلن في النفوس التي تقل حساسيتها لمفاعيل هذه التجربة المجردة، فأهل الأذواق يفهمون ما كتب في الأوراق، إذا فالرمز لا يستعلن بذاته ، الأمر الذي أضفى عليه خفاء من جهة ذاتية، وظهورا من جهة نفس المتلقي القابلة، وهو على نقيض الرمز الرياضي، الذي من مهمته أن يقصي التكثر في وجوه التأويل أو التفسير ومثال ذلك في خمرية ابن الفارض، تأويل الحبيب بحضرة رسول الله( صلى الله عليه وسلم)، أو تأويله بذات الخالق القديم، و تأويل حانوت الخمار بحضرات الذات العلية،أو بكل شيء يتجلى فيه الوجود الحق،والتأويل في الخمرية يقوم على التناسب بين المشار به والمشار إليه، والمشار به هنا هو المعطى الحسي، والمشار إليه يتجاوز ذلك المحسوس إلى معان مجردة خالصة، كما قلت غير مرة.
(2 )
وإذا كان ثمة تناص في المضمون بين تجليات ابن الفارض وفلسفة أفلاطون في تفسير الوجود الحسي،من خلال تقرير غربة الروح، التي يرى أفلاطون أنها هبطت من عالم مثالي كامل لتشقى مدة في عالم الحس، ثم تعود إلى عالمها الأول، والتي يرى ابن الفارض أنها شربت يوم الميثاق عهد الولاء الأزلي، ثم أتت هذا العالم غريبة، تحاول فك قيود الهوى عساها تعود إلى ولاء الوطن الأول4، فإننا نجد كذلك نوع تناص في الرموز الصوفية تتكاثف لتكوين بنية نصية غنوصية مغرقة في البعد، فإن هذه الخمرية الصوفية لم تكن لتبدأ من فراغ خالص، وإنما استلهمت ذلك التراث الهائل للشعر الخمري والغزلي، واستلهمت صوره وأخيلته وأساليبه، لكنها لم تستلهم بعده الحسي، الذي يستنهض ما هو مخبوء في النفس من كراهة ونفور؛ لذلك فإنني وصفت صورة الاشتباك النصي هنا بنوع تناص، وقد جاءت استراتيجيات التناص في هذا الفن الروحي، ملائمة لهذا الاستغراق الماورائي للنفس، لأنها استعارة نصية شكلية ، يمكن أن أشبهها بقاعدة أرضية لبداية تحليق الروح إلى ما وراء الفضاء الدلالي .
(3 )
والرمز في الخمرية يلبي تجليات النفس بمختلف أدوراها، ويساوقها أنى حلت وارتحلت واستقرت، فالنفس إذا ارتكست في عالم الفانيات، وانقطع وارد جمعها، اختفت عن ظهورها الحقيقي، وباينت وجودها المطلق، وهذا الحال هو صحو ما قبل السكر ومدامة التبين ، فهو كرم لا خمر، هو عصير الخمر لا نشوتها ولذتها، ولكن النفس التي انجذبت بوارد المحبة، وترقت بنداء النفحات، وزكت بأزكى الرشحات، وأزهر نَــورها بفضل جمال هواطل القربى، وساحت في ساحات ضواحك السحاب ، وأدركتها حقيقة أنوار الإيمان، وتطهرت من وفور العوائق وهجوم العلائق، وسارت في الله بعد التحقق بالفناء المطلق، فقد دخلت عرصات الحانة، وشربت مدامة المحبة، وانتظمت في سلك أهل الأديرة، وسكرت وانتشت وطربت واهتزت، وهجرت إلى ديار تحققها بالوجود الأوحد.
وقد يرتبط هذا بتقسيم الصوفية حالات النفس المهاجرة ثلاثة أقانيم مترابطة : السكر، والبسط ، والشطح، فالبسط ما تستحقه النفس من جرا اتهامها بالزندقة والمروق؛ فتنبسط عندما تظفر بحقيقتها ، فتغمرها غبطة بلا حدود فتسكر بمطالعة الجمال، وشهود النورانية القدسية، ثم تشطح لتصرف ملقية أحوالا عجيبة وعبارات غير مألوفة؛ سرورا منها بمشاهدة الجمال، وهذه الحالات الثلاث تملأ الذات بحقيقتها الوجودية، فتنطق بما يبهر، وتعلن على الأشهاد وهي منتشية وجودها وتحققها، بتلويحات ورموز ذوقية ، ولغة مفعمة بالمفارقة.
(4 )
ومن سمات الرمز في الخمرية، الجزئية المفرطة؛ فلا يأتي مضمونه في كلية خصبة قوامها السياق الحي للتجربة الروحية1 ، وهذا ما أدى إلى تكثر الرموز من جهة ، والإغراق فيها، واعتياص التناول، ولعل لهذا ارتباطا بتبعض الرحلة الروحية، وتمرحلها على وفق أحوال مختلفة، وتجليات متعددة، ثم إن تناول التجربة الروحية بمنحى كلي، يفقد هذه التجربة
قيمتها، وإحساسها بكل جزء تعنته في هذه الهجرة إلى ما وراء الحس، وكأنني بابن الفارض يرفض في توحده أن تكون تجربته الروحية مقسما، تعتورها جزئيات وكليات، فكل رمز عنده يشبه الجوهر الفرد المعبــِّر عن جوهر فرد.
( 5)
وفي المقابل يطالعك ابن الفارض أحيانا بما يشبه الصدمة، فيفقد الرمز عنده هذا الإبهام الذي هو من متطلبات وصف التجربة الروحية، ويعمد في بعض شعره إلى كشف اللثام عن القرينة الموضحة للرمز، كما في قوله :
وقد وقع التفــــريق والكل واحد فأرواحنا خمر وأشــــــــباحنا كرم
ويغلب على ظني أن سبب هذه المقاربة الرمزية ، يرجع إلى مراتب الترقي والهبوط في النفس، فالرمز يعتاص ويغرق في ظلمات التماهي؛ بمقدار انفكاك النفس في فنائها عن ملاحظة قرائن الألفاظ والدلائل، فالرمز الصوفي يتحقق بتحقق الفناء، ويضمحل بتقرر البقاء، فهو في مراتب الغموض والجلاء تابع لمراتب الفناء والبقاء بالمعنى الصوفي ، والصوفي الذي يرتاح بالحيرة ويتبيّــن بالبين، لا يملك إلا أن تستعلن لغته في حالة من التوتر وعدم الاستقرار؛ الناشئ عن هذا الازدواج والانزياح والهروب من قبضة المألوف .
ملحوظة : هذه دراسة فنية لا تمثل موقفا فكريا
بقلم : عماد الزبــن
أـــ توطئة
يعد ابن الفارض بحق من أبرز شعراء العصر الأيوبي ، ورائد من كتب في الشعر الصوفي بعده، وكان صاحب مذهب في التلويح الصوفي والإشارية المغرقة ، يشهد بهذا شعره الذي يدخلك في سيميائيات غنوصية يصعب عليك معها إلا أن تتجرد عن حسك لتجاري تلويحات سلطان العاشقين ، وابن الفارض في شعره يضايف بين التجربة الصوفية والفنية الشعرية ؛ الأمر الذي أغنى شعره بالرموز والإشارات والتلويحات ؛ ولا أظنني أبالغ إذا قلت إنه جدد في طريقة التلويح والتعبير الإشاري في عرض المواجيد والحالات والانجذابات التي عبر عنها عبر جريان الرمز الصوفي؛ المشعر بضيق اللغة الحسية عن دوائر اللامعقول ، والتجليات الميتافيزيقية للروح ،" لقد كان صوفيا غلبه السكر، واستبدت به النشوة ، يسمع فيستخفه الوجد ، وتغشى أعضاءه الحركة، ويقهره وارد السمع، فلا يملك له صرفا" فيسوح في سبل الفناء؛ يطوي واردات البقاء، ليظل في شهود المشهود، هوعالم من التلاقي يكسر حاجز المعقول والحس، ولا يصلح البوح به إلا بكسر حسيات اللغة، حتى تنتظم اللغة بما يشبه الازدواجية الدلالية بين البقاء المحس ، خطاب العامة، والتجلي المبني على الفناء، خطاب الخاصة الخالصة، وهو بهذا يعبر عن تجربة وجدانية لها مقتضياتها التي تشحن اللغة بحالة من التوتر الدلالي، يظهر بهذه التلويحات والإشاريات الميثوصوفية ، وهو يخط طريقا، ويبني ما يمكن أن أسميه منهجا في الشعر الصوفي، ظهر من خلال السمات الرمزية والانزياح الرمزي ، كما وكيفا ، عما كان قبله، وتظهر قيمة هذه السبيل، بالشعراء السالكين من بعده، الذين مخروا عباب بحره اللجي ، ونسجوا على منواله الخفي ، في إشاراياتهم ورموزهم ، وتجلياتهم الماورائية .
ولما كان الرمز من أعظم سمات الشعر الصوفي، وأجلاها في الفضاء الروحي الذي ينداح فيه شعراء التصوف بتجاربهم الوجدانية، رأيت أن أقصر تقريري هذا عليه ؛ منطلقا من قراءة خمرية ابن الفارض التي ربما يسوغ لي أن أسميها المثال الأسمى للتجربة الشعرية الصوفية .
ب ــ الرمز الخمري : الحس والتأويل
يقرر عبد الغني النابلسي ، شارح ديوان ابن الفارض، أن هذه القصيدة مبنية على اصطلاح الصوفية،1فيدفع القارئ في بداية نظره في هذه القصيدة، إلى رفع حجب الحس عن دلالاتها ومضامينها، وأنت خبير بعد، بأن هذه القصيدة مؤسسة على رمز الخمر والسكر في الأدبيات الصوفية؛لذلك عمد بعض الشراح إلى وسمها بالخمرية .
( 1 )
لجأ ابن الفارض وهو يعبر عن الحب الإلهي إلى الخمر والمدامة، ووشاها بالرمزية الدالة على الأزلية، أراد بهذا الرمز أن يكسر ضيق الزمان والمكان؛ ليعبر عن تجربة لا تحدها قيود الزمان و المكان، أراد أن يعبر بالخمر والسكر عن غيبة تكسر طوق الالتزام بعالم الأشباح، والغيبة هنا فناء عن ملاحظة التكثر، والسكر انتشاء بما أداره الحبيب على ألباب السكارى من لذة التوحد والقرب والمعرفة2، والخمر بهذا التلويح توجب الغيبة عن جميع الأعيان الكونية،غيبة تكسر طوق : قبل وبعد ومتى، ليتلذذ السكارى بنشوة التلاقي الروحي في سابق الحضرة العلمية قبل ظهور كل ممكن ، وتقدير كل مقدور،فيغدو السكر استجابة لوارد قوي لا يتجلى إلا في نفس قابلة متمردة على سجن الأشباح، إنها نفوس أصحاب المواجيد وجزء من مقام الولاية فالخمر هنا ليست الخمر الحسية، بل رمز يحملنا على التأويل الصادر عن كسر حجاب الحسيات، وهذا التأويل مرتبط بالأثر النفسي والروحي؛ فالسكر الصوفي غيبة وليس غشية، خمر معنوية ترجع الروح إلى الاتحاد مع المحبوب، الذي يمثل حبه أصل وجود المتعينات، والمعنى الحقيقي لحركة المتحركات.
ولم يدر ابن الفارض خمريته على لغة تجريدية جافة، وإنما ساقها مشربة بالرمز جياشة بالصور،فجاءت لغة موسومة بطابع الوحدة الصوفية ، وجاءت الخمر فيها تعبيرا جياشا عن افتراق الروح وهجرة النفس بوارد الجمال الإلهي ، خمر أزلية شربتها الأرواح المجردة؛ فانتشت وطربت وترقى مزاجها ، من قبل أن تحصر في عالم المحدثات المسور بسجن الإمكان
شربنا على ذكر الحبــيب مدامــــة سكرنا بها من قبل أن يــُخلق الكرم
لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال ، وكم يبــدو إذا مزجــت نــجم
ولولا شـــذاها ما اهتـــديت لحانها ولولا ســــــناها ما تصورها الوهم
ولم يُبق منها الدهر غير حُــشاشة كأن خَفاها في صــــدور النهى كتم
وإذا كانت المدامة رمز الحب الإلهي الأزلي، فإن شاعرنا يغرقنا في نهر جار عذب من الرموز المرتبطة بالخمر، الأمر الذي يحملنا على تأويل هذه التلويحات في فضاء المعنى المومى إليه في عين المحبة الأزلية، فهذه رموز تمظهر المحبة الأزلية، إنها مظاهر الآثار الكونية التي تعكس هذه المحبة بما يشبه الانعكاس المرآوي ، فالشمس هي محبة الإله وإشراق لطفه، ووارد جماله على البواطن القابلة المستجيبة المشرقة بهذه الاستجابة ، إنسان كامل مرموز إليه بالبدر الذي يستضيء بشعاع وارد المحبة، وبالكأس من حيث هو مظهر للمقام الأعلى، وبالهلال إذا احتجب بظهور نفسه عن إظهار بقية النور، وبالنجم إذا نظر إلى غيره، وانقطع وارد اتحاده بملاحظة الأغيار، فمزجت محبة الإله بمحبة الغير .
وهذه المدامة المكنى بها عن الحقيقة الجامعة الوجودية الإلهية ، تظهر كالبرق وتلمع في النفس كلمح البصر، فلولا روائح تلك الحضرات الحاملة للسر المصون ما استعلنت هذه المحبة، فأنت ترى أن الشاعر يستعين بكل ما يجاور الخمر من ألفاظ : الكأس والشذا والحانة والروائح و الحشاشة ، ويعبر بها عن تجربة روحية لا تستعلن إلا وهي تلجئنا إلى محاضن التأويل، بل إن شاعرنا يقرر أن الركون إلى المحسّ، والاقتصار على التعقل المجرد يقصي فهم هذه التجربة الروحية، ويدخلها في الزخارف العقلية المحسة ، فلا يبقى من هذه المدامة في القلوب حشاشة روحية، أو بقية روح أمرية .
ولم يُبق منها الدهر غير حُــشاشة كأن خَفاها في صــــدور النهى كتم
(2)
وما زال شاعرنا يمتح من فيض اللذة الروحية، ما يشعرنا بضيق اللغة الخاضــعة للمواضعة المحسة، فأنى لمن تريض في مضمار عين المحبة الإلهية، أن يرتكس بملاحظة الدلالات الوضعية، وهذا ما يشعر القارئ بالتوتر الدلالي وهو يسوح في فضاء الخمرية الفارضية. ويهبط المستوى الخطابي الروحي عند شاعرنا ، أحيانا، ليذكرنا أن خمر الروح ومدامة الوجد لا يبتنى عليها إنكار أو إثم، بل هي إشراق أنوار التجليات الإلهية على قلوب الذاكرين، الناسخة لظلمات الغفلة والركون إلى الأغيار، وكأنه بهذا فقد وارد الاتحاد بملاحظة أحكام الأغيار على التجربة الروحية، والذي يؤكد ما قلته أنه ينعى على المريدين الصادقين خفاء العلوم الإلهية من صدورهم، لتقاصر هممهم، فلم يبق منها إلا الاسم، وكأنني بابن الفارض ينعى نفسه التي فقدت هذا الوارد من التجلي؛ بما تحقق لها من الأنس بغير مدامته الأزلية، فهي كما تقرر سابقا، كلمح البصر، ظهورا وخفاء، تظهر في نفسه وتغيب، فلا غرو بعد، أن يبين شاعرنا أثرها في النفس القابلة وما تشيعه في النفس من أفراح ونفي للهموم .
فإن ذُكرت في الحي أصبح أهله نشاوى ولا عار عليـــــــهم ولا إثم
ومن بين أحشاء الدنان تصاعدت ولم يبق منها، في الحقيقة، إلا اسم
وإن خطرت يوما على خاطر امرئ أقامـــت به الأفراحُ وارتحل الهــــم
وتظهر هنا الدنان وبعدها الرمزي المرتبط بالخمر، فهي صدور المريدين التي غابت عنها الحقيقة المدامية، وهؤلاء المريدون هم أهل الحي، أصحاب النفوس القابلة لهذا التجلي للحقيقة المدامية .
(3)
وقد بدا بوضوح، أن ما ذكره ابن الفارض في خمريته، ينحل إلى ضرب من التكافؤ بين البنية الحسية للأشياء في قربها ومباشرتها، والبنية العرفانية المرموزة، وفي هذا الفضاء من الازدواج يؤول ما نسبه الشاعر إلى الخمر من صفات وآثار في النفوس إلى كيفيات يسيطر عليها طابع التلويح الرمزي، وتكتنفها التجليات السيميائية التى، دون اعتبارها، تجد نفسك تقرأ في فضاء خارج عن مراد شاعرنا، وتطير خارج السرب الوجداني الذي يتعنى تقريره، وهذا في قصيدته كالميت بالجهالات والشهوات، يبعث إذا ما ذاق هذه المدامة الإلهية، والمقعد الذي لا نهوض له إلى معرفة ربه، فإنه متى ولج ليل الوجد، وسكر بشراب المحبة المنزهة؛ أنهضه هذا الشراب وابتعث إرادته وهمته، وكذلك المزكوم الذي لا يشتم طيب الأنفاس الرحمانية، ولا يجد عــَرف التجلي الإلهي في الأكوان، وهي بعد ذلك نجم يهدي ورقيقة تشفي، وذوق يهذب أخلاق السالكين، وسكر يفضي إلى العزم،1إنها نشوة روحية تحيل النفس إلى غير طباعها، وتخرق مألوف التردي في هذه النفوس؛ لأنها هجرة روحية تتعالى على مقتضيات البقاء الحسي، لتدّغم في أحكام الكمال الروحي الأزلي .
ولو نظر النُدمان ختم إنائـــــها لأســـكرهم من دونها ذلك الــختم
ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعـش الجسم
ولو طرحوا في فيء حائط كرمها عليلا وقد أشفى لفارقه الســــــــقم
ولو قربوا من حانها مقعدا مــــشى وينطق من ذكــرى مذاقتها البـــكم
ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها وفي الغرب مزكوم لعاد له الـــشم
ولو خُضّــبت من كأسها كف لامس لما ضل في ليل وفي يده النــــــجم
ولو جليت ســـــرا على أكمــهٍ غدا بصيرا، ومن راووقها تـَسمع الصمّ
ولو نال فَــــَدم القــوم لثــم فِــدامها لأكــسـبه معنى شـــــــــمائلها اللثم
ولو رسم الراقي حروف اسمها على جبين مصاب جنّ ، أبرأه الرســــم
تهـــذب أخـــلاق النــَدامى فيهــــتدي بها لطـــريق العزم من لا له عزم
ويـــــَكرُم من لم يعرف الجـــودَ كفّـــُه ويحلُم عند الغيـــظ من لا له حِــلم
ولو أن ركبا يــمموا تــرب أرضـــــها وفي الركب ملسوع لما ضره السم
(4 )
وخمر ابن الفارض ، خمر معتقة في أعطاف الأزل 3، يعنى شاعرنا بتقرير تعاليها عن الوصف، وعند وصفها يطرح رموزا أجاءتنا إلى تأويل هذا التلويح الجديد من واقع التذوق الذي يستعصي على غير أصحاب الذوق، فما لنا من حظ في تفهم هذا المشرب الراقي الذي يعبر عنه صاحبنا، إلا بمقدار ما نلاحظ المناسبة الحسية في طرحه الروحي، شيء يشبه التناص بين الروحاني والترابي؛ للوصول إلى رتبة مشوبة بهذه المعاني المستغلقة من تجليات الروح، نسل بها إلى التجربة المدامية لفارضية.
ويتقرر في فضاء الرمز في خمرية ابن الفارض الفرق بين ذات المحبوب ، والمحبة المعبر عنها بالمدامة، فابن الفارض عندما يُسأل عن أوصاف المدامة ، أي عن طريق المحبة إلى المحبوب، يحتجب إحساسه بغير ادّغامه بها، وتستعلن نفسه الخبيرة بهذه الأذواق، فعنده وصفها وهو الخبير بها، ولا يحملنك هذا على الشعور بتناقض مواقفه إذا قرأت قوله في التائية
فلو قيل من تهوى وصرحت باسمها لقيل : كنَـى ، أو مسه طيف جنة
فهو في التائية يشير إلى نفس الحبيب، وعلمه ليس سهلا ، ومن شأن العارفين نفي قرب معرفة نفس الحبيب، ومنه قول العارف السيد أحمد الرفاعي:
يسائلني عن سر ليلى رددته بعمياء من ليلى بغير يقين
يقولون خبرنا فأنت أمينها وما أنا إن خبرتهم بأميــن
ويبدأ ابن الفارض في بيان أوصاف المدامة، فلم يبق من الخمر في شعره إلا اسمها، إذ إنه نزع عنها الثوب الحسي الذي ترفل فيه في فضاء الصورة الذهنية، وحرمها التحقق، وجعلها تنأى بجوهرها عن دلالة الوضع، فليس ثَـم إلا السكر والغيبة والانتشاء ، ويمكن أن نقف هنا على الكيفيات التي تحوّل الموضوع بها إلى رمز شعري، فيه إحالة موحدة بين الحسي والمثالي، بين العيني في واقعيته والمجرد في تعاليه، فهذه الخمر تتجاوز المعطى المادي إلى وصيد مثالي مجرد، ويبدو هذا التجريد المثالي في وصف الخمر العرفانية بالخلوص من كثافة العناصر، فهي صافية نورانية 3، تتجلى بالمعاني المجردة، لا الصور المحسة، لا يتعنى شاربها كدورة الخمر الحسية، وهي روح مجرد عن دواعي الجسمية، وعن رسوم الأعيان، سابقة لكل متعين، متعينة في حضرة العلم الإلهي الأزلي، ثم يجعل من هذه الخمر النورانية محل قيام المتعين، ويتوسل بالرمز إلى معنى احتجابها عن المحجوبين الدائرين في فلك المحسات، بتعاطي ما يجتال قلوبهم بعوائق التشوق إلى زخارف الدنيا، ثم يقيم شاعرنا بمنظومة رمزية، ثنائية اعتبار الوجود من خلال الملاحظة، فالروح المتعينة في العلم الإلهي امتزجت واتحدت بهذه المدامة، وهامت بها قبل كينونة العوالم التي لا وجود لها إلا بالوجود الظاهر عليها وهو وجود الحق، فهي " ثنائية عرفانية بين التجلي الأمري الوجودي وعالم الإمكان، وتشير إلى أن الصوفي العارف يتلون بها، فتارة لا يشهد إلا الخمر بوصفها رمزا على العلو، ... وتارة لا يشهد إلا الكرم فيكون في مقام الفرق، ولا خمر في هذه الحال موجودة؛ لأن الوجود واحد"
يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير ، أجل عندي بأوصافها علم
صـــفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جســــم
تقدم كلَّ الكائنـــــــــات وجودُها قديما ولا شكل هناك ولا رســـــم
وقامت بها الأشــياء ثَــم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم
وهامت بها روحي بحيث تمازجا اتـــ ــحادا ولا جـــــرم تخلله جــــــرم
فخـــمر ولا كــرم ، وآدم لي أب وكرم ولا خمـــــر ولي أمـُــــها أم
ولطف الأواني في الحقيقية تابع للطــف المعاني والمعاني بها تنمو
وقد وقع التفــــريق والكل واحد فأرواحنا خمر وأشــــــــباحنا كرم
وانظر كيف يرمز بالأواني إلى عالم الإمكان، وأنها في حقيقية الأمر الإلهي تابعة للطف المعاني
التي هي دوالّ صور الممكنات على الحضرات الإلهية، والتجليات الربانية، وهو ما لا يدرك بالعقول، وينأى عن منافذ الحواس.
( 5)
ثم يختم شاعرنا قصيدته بأبيات استقرت في صميم الرمز العرفاني، وكأنه تخلى عن تجرده ليواكب لغة الخمريين في طابعها الحسي، مهيبا في رمزيته الصوفية بلغة لا يكشف ظاهرها بقدر ما يغطي ويعمي، حتى إنه ليتوسل بألفاظ تثير انطباعات مستمدة من لغة شعراء العبث والمجون1، ويقيم ما يشبه المحاججة في نفي الإثم عن شرب مدامته، ويقرر أن ترك شربها هو الإثم، وهو بهذا يلوح إلى نفي الحسية عن مدامته، ولا يفتأ شاعرنا يذكرنا بتجرد مدامته عما نعبه من أغوار أذهننا من صور محسة، وتتكثف رموزه وتلويحاته في سيميائية مغرقة؛ لتغوير منابع المألوف ، وتكدير مشارع المعقول، إن رموزه كسر لحجب الإلف، وخرق لعادية المنظومة اللغوية الدلالية، وقهر لسطوة التعالي العقلي، وتحكمات الحواس .
ويتابع شاعرنا المتح من معجم الغزليين الماجنين ، بما يقدمه من حديث عن الحواني والأنغام وترشف رضاب الحبيب، وأنه لا عيش بلا خمر2 ، وما يتبع الخمر من نشوة ونشاط ، ومزج المدامة، ويقدم منظومة إشارية تعتاص على العقول متى شدت إلى إلفها الدلالي، ويجعل مدامته صافية لا تقبل الأخلاط، ملوّحا إلى معنى الجمع الصوفي وهو التوحد في شهود الحق،
وجعل المزج لخمرته بمعنى النزول من حضرة الجمع إلى تكثر الأشباح، الناقض لمعنى التوحد، ودعا إلى تحقق شارب المدامة النورانية ، على فنائه واضمحلاله، في الوجود الحق، الذي هو به موجود، وهذه الرموز لا يحملها على ظاهرها إلا الذي لم يشامّ رائحة الذوق، وهي تتكاثف وتتصاعد لتحقق المضمون الوجودي، وتنفي الوجود المتكثر من حيث هو وجود، بما يؤسس لوحدة الوجود ، ووحدة الشهود، وإذا كانت المدامة ، على ما يقرره النابلسي،3 هي الوجود الحق الواحد الأحد، فإن حانة الخمار تمثل كل شيء، لأن هذا الوجود الحق له ظهور وتجل وانكشاف بتقدير كل شيء وتصويره.
ومن علامات التحول العرفاني لرمز الخمر، الكلام على الأديرة المسيحية والرهبان والنواقيس، بما يذكرنا بالخمريات الحسية في العصر الجاهلي، ويحدثنا الأستاذ عاطف نصرعن وجه الارتباط بين الطقوس المسيحية والخمريات الجاهلية فيقول : ويرجع الارتباط إلى أن نفرا من تجار الخمر كانوا من نصارى الروم، وأن نفرا من الجاليات المسيحية التي اختلطت بالعرب، كانوا يعاقرونها،5 أما الصوفية فقد اتجهت بهذا الارتباط متجها آخر، رمزت من خلاله بأهل الأديرة إلى العرفاء الذين ورثوا مقاما عيسويا روحانيا،6 فهؤلاء الصوفية تذكروا هذه المدامة وأشرفوا بها على عالم الأرواح المجردة عن الظلمات؛ فزج بهم في النور المحمدي الجامع لجميع مقامات الأنبياء. ثم يسعى صاحبنا إلى ذم الصحو الأول الحاصل من انتفاء المدامة النورانية، وصولا إلى الترقي بمعاني الصحو الثاني الحاصل من السكر النوراني؛ لانكشاف الحقائق الأزلية .
وقالوا شـــربت الإثم كلا وإنما شربت التي في تركها عنديَ الإثم
هنيئا لأهل الدير كم سكروا بها وما شربوا منها ولكنهم همّـــوا
فعنديَ منها نشوة قبل نشــــأتي معي أبدا تبقى وإن بلي العظــــــم
عليكَ بها صِرفا وإن شئت مزجها فعدلُـكَ عن ظلم الحبيب هو الظلم
ودونكها في الحان واستـــــجلها به على نغــــم الألحان فهيَ بها غُـنـم
فما ســــــــكنت والهــمَ يوما بموضع كذلك لم يســــــكن مع النغم الغم
وفي سكرة منها ولو عمر ســـــــاعة ترى الدهر عبدا طائعا ولك الحكم
فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحيا ومن لم يمت سكرا بها فاته الحزم
على نفســـــــه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا ســــهم
جـــ ــ نظرة تحليلية في الرمز
يضيق الصوفية باللغة الحسية التي لا تفتأ تنداح في دوائر الأنا المحس، والأين المحيّـز، والكيف على وفق هيئة متعينة، و (المتى ) وقيود الزمن الاعتباري، وإن كانوا يوهمون الوقوف عند المحس، فلستر محبتهم، وسدل الأستار على مكاشفات الأخيار، حالة من ستر الأسرار عمن ارتكس في المحسات من الأغيار، ولعلك تلحظ هذا في ردة فعل ابن عربي الذي ثار عندما حمل بعض الناس تغزله في نظام ، ابنة شيخه، على ظاهره؛ فبادر إلى شرح ديوانه شرحا ذوقيا مؤسسا على التلويح وهتك حجب المحسات، ويعبر القشيري عن إرادة الصوفية بهذا الاتجاه الرمزي بقوله : " قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم، والإجمال والستر على من باينهم في طريقتهم؛ لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب؛ غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها".
وههنا ينجم تسآل: هل كان الصوفية يكتبون لأنفسهم، ولم يكن من إرادة الصوفي المجذوب بالحال أن تستعلن تجربته الروحية بخصائصها الذوقية؟ وإذا كان ذلك كذلك، فلماذا لم تظل هذه التجارب الروحية مدفونة في الصدور؛ فمن أخص قواعدهم أن صدور الأحرار قبور الأسرار4، والذي يبدو لي، أن القوم اعتمدوا الاستقطاب النخبوي في خطابهم؛ وكانت كتاباتهم فيضا عاطفيا تعالى على سدود الأسرار، فراحوا ينأون بخطابهم عن المتبادر إلى أذهان من هم خارج التجربة الروحية، وأحوجهم الاستقطاب النخبوي إلى الانزياح الدلالي ، من الاستعارات والكنايات وأنواع المجاز، بل أحوجهم إلى اعتماد التواضع الذاتي بل ما يشبه الاصطلاح مع النفس ، لذلك وقع هؤلاء المجاذيب بما يشبه الدائرة المغلقة مع أهل الظاهر المحكومين بالمحسات اللغوية الظاهرة، فأنكر هؤلاء أشد الإنكار على المتصوفة ما يجدونه في كتبهم من تلويحات خارج فضاء المحس؛ لأن هؤلاء المنكرين أقاموا منآد ما يقرؤون بثقاف الكليات اللغوية الظاهرة، ولم يشعروا أن القوم يسوحون في فضاء آخر، تندلث فيه الكلمات عارية عن أسمال الدلالة المتواضعة، ومن جهة أخرى انشغل هؤلاء المتصوفة بفضائهم الروحي الرحب عن ملاحظة الأغيار؛ فكان في رد اتهام أهل الظاهر قطع للادّغام الروحي والوحدة الشهودية، وهبوط إلى شواحط أودية الفانيات، فلا يردّ المجذوب قالة الأغيار إلا في حال انقطاع الوارد. وأنت تجد هذا المعنى في موقف رجل مثل الذهبي؛ الذي أبعد النجعة وهو يتكلم على صوفي مثل ابن الفارض، فاتهمه بالكفر والإلحاد؛ وما هذا إلا لأن الذهبي قد غور ينبوع الذوق الروحي في نفسه بما يتعناه من الجرح والتعديل وحسب، وأنت خبير بعد، بأن تفاوت التجربة الصوفية حمل بعض الصوفية على إنكار هذه الرموز وهذه الطريقة من التعاطي مع التجربة الروحية .
عماد أحمد الزبن
28-11-2007, 14:34
(1)
والذي ألجأ الصوفية إلى هذه المنظومات الرمزية، ارتباط فحوى التجربة الصوفية بالمحل المباين للمحسوس، وأعني به القلب، فإذا كان القلب، على حد تعبير الغزالي، خارجا عن إدراك الحواس1؛ فإن عجائب القلب وما يتجلى فيه من فيوض ، وانكشاف عرفاني، لا تخضع للحس أيضا، فالصوفي بهذا يعبر عن غير المحسوس بمثال محسوس، وهذه الازدواجية أدت إلى تعدد وجوه التأويل للرمز الصوفي، لأن التأويل ارتبط بحال القارئ أيضا في جهة من الجهات، أقصد حاله الروحي، فصار التأويل يستعلن في النفوس القابلة لهذا المشرب الروحي بصورة مجردة أكثر مما يستعلن في النفوس التي تقل حساسيتها لمفاعيل هذه التجربة المجردة، فأهل الأذواق يفهمون ما كتب في الأوراق، إذا فالرمز لا يستعلن بذاته ، الأمر الذي أضفى عليه خفاء من جهة ذاتية، وظهورا من جهة نفس المتلقي القابلة، وهو على نقيض الرمز الرياضي، الذي من مهمته أن يقصي التكثر في وجوه التأويل أو التفسير ومثال ذلك في خمرية ابن الفارض، تأويل الحبيب بحضرة رسول الله( صلى الله عليه وسلم)، أو تأويله بذات الخالق القديم، و تأويل حانوت الخمار بحضرات الذات العلية،أو بكل شيء يتجلى فيه الوجود الحق،والتأويل في الخمرية يقوم على التناسب بين المشار به والمشار إليه، والمشار به هنا هو المعطى الحسي، والمشار إليه يتجاوز ذلك المحسوس إلى معان مجردة خالصة، كما قلت غير مرة.
(2 )
وإذا كان ثمة تناص في المضمون بين تجليات ابن الفارض وفلسفة أفلاطون في تفسير الوجود الحسي،من خلال تقرير غربة الروح، التي يرى أفلاطون أنها هبطت من عالم مثالي كامل لتشقى مدة في عالم الحس، ثم تعود إلى عالمها الأول، والتي يرى ابن الفارض أنها شربت يوم الميثاق عهد الولاء الأزلي، ثم أتت هذا العالم غريبة، تحاول فك قيود الهوى عساها تعود إلى ولاء الوطن الأول4، فإننا نجد كذلك نوع تناص في الرموز الصوفية تتكاثف لتكوين بنية نصية غنوصية مغرقة في البعد، فإن هذه الخمرية الصوفية لم تكن لتبدأ من فراغ خالص، وإنما استلهمت ذلك التراث الهائل للشعر الخمري والغزلي، واستلهمت صوره وأخيلته وأساليبه، لكنها لم تستلهم بعده الحسي، الذي يستنهض ما هو مخبوء في النفس من كراهة ونفور؛ لذلك فإنني وصفت صورة الاشتباك النصي هنا بنوع تناص، وقد جاءت استراتيجيات التناص في هذا الفن الروحي، ملائمة لهذا الاستغراق الماورائي للنفس، لأنها استعارة نصية شكلية ، يمكن أن أشبهها بقاعدة أرضية لبداية تحليق الروح إلى ما وراء الفضاء الدلالي .
(3 )
والرمز في الخمرية يلبي تجليات النفس بمختلف أدوراها، ويساوقها أنى حلت وارتحلت واستقرت، فالنفس إذا ارتكست في عالم الفانيات، وانقطع وارد جمعها، اختفت عن ظهورها الحقيقي، وباينت وجودها المطلق، وهذا الحال هو صحو ما قبل السكر ومدامة التبين ، فهو كرم لا خمر، هو عصير الخمر لا نشوتها ولذتها، ولكن النفس التي انجذبت بوارد المحبة، وترقت بنداء النفحات، وزكت بأزكى الرشحات، وأزهر نَــورها بفضل جمال هواطل القربى، وساحت في ساحات ضواحك السحاب ، وأدركتها حقيقة أنوار الإيمان، وتطهرت من وفور العوائق وهجوم العلائق، وسارت في الله بعد التحقق بالفناء المطلق، فقد دخلت عرصات الحانة، وشربت مدامة المحبة، وانتظمت في سلك أهل الأديرة، وسكرت وانتشت وطربت واهتزت، وهجرت إلى ديار تحققها بالوجود الأوحد.
وقد يرتبط هذا بتقسيم الصوفية حالات النفس المهاجرة ثلاثة أقانيم مترابطة : السكر، والبسط ، والشطح، فالبسط ما تستحقه النفس من جرا اتهامها بالزندقة والمروق؛ فتنبسط عندما تظفر بحقيقتها ، فتغمرها غبطة بلا حدود فتسكر بمطالعة الجمال، وشهود النورانية القدسية، ثم تشطح لتصرف ملقية أحوالا عجيبة وعبارات غير مألوفة؛ سرورا منها بمشاهدة الجمال، وهذه الحالات الثلاث تملأ الذات بحقيقتها الوجودية، فتنطق بما يبهر، وتعلن على الأشهاد وهي منتشية وجودها وتحققها، بتلويحات ورموز ذوقية ، ولغة مفعمة بالمفارقة.
(4 )
ومن سمات الرمز في الخمرية، الجزئية المفرطة؛ فلا يأتي مضمونه في كلية خصبة قوامها السياق الحي للتجربة الروحية1 ، وهذا ما أدى إلى تكثر الرموز من جهة ، والإغراق فيها، واعتياص التناول، ولعل لهذا ارتباطا بتبعض الرحلة الروحية، وتمرحلها على وفق أحوال مختلفة، وتجليات متعددة، ثم إن تناول التجربة الروحية بمنحى كلي، يفقد هذه التجربة
قيمتها، وإحساسها بكل جزء تعنته في هذه الهجرة إلى ما وراء الحس، وكأنني بابن الفارض يرفض في توحده أن تكون تجربته الروحية مقسما، تعتورها جزئيات وكليات، فكل رمز عنده يشبه الجوهر الفرد المعبــِّر عن جوهر فرد.
( 5)
وفي المقابل يطالعك ابن الفارض أحيانا بما يشبه الصدمة، فيفقد الرمز عنده هذا الإبهام الذي هو من متطلبات وصف التجربة الروحية، ويعمد في بعض شعره إلى كشف اللثام عن القرينة الموضحة للرمز، كما في قوله :
وقد وقع التفــــريق والكل واحد فأرواحنا خمر وأشــــــــباحنا كرم
ويغلب على ظني أن سبب هذه المقاربة الرمزية ، يرجع إلى مراتب الترقي والهبوط في النفس، فالرمز يعتاص ويغرق في ظلمات التماهي؛ بمقدار انفكاك النفس في فنائها عن ملاحظة قرائن الألفاظ والدلائل، فالرمز الصوفي يتحقق بتحقق الفناء، ويضمحل بتقرر البقاء، فهو في مراتب الغموض والجلاء تابع لمراتب الفناء والبقاء بالمعنى الصوفي ، والصوفي الذي يرتاح بالحيرة ويتبيّــن بالبين، لا يملك إلا أن تستعلن لغته في حالة من التوتر وعدم الاستقرار؛ الناشئ عن هذا الازدواج والانزياح والهروب من قبضة المألوف .